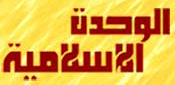|
|||||||
|
تعددت الحملات السياسية والإعلامية الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والرامية إلى إدراج ملف "قضية اللاجئين" اليهود من الدول العربية المفتعلة، على جدول أعمال الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أطلقت حملة جديدة تحت عنوان "أنا لاجئ يهودي"، تطالب بتعويض اليهود الذين غادروا الدول العربية واستعمروا فلسطين بتشجيع من الوكالة اليهودية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على غرار المطالبة بتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من وطنهم إلى الشتات. وكشفت صحيفة "هآرتس" الصادرة في 14/9/2012 عن مضمون وثيقة رسمية إسرائيلية أعدها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحمل العنوان التالي: "خلاصة العمل الأركاني واقتراح الموقف الإسرائيلي في المفاوضات مع الفلسطينيين في موضوع اللاجئين اليهود" تتضمن الموقف الرسمي الذي يفترض بتل أبيب أن تعرضه في قضية "اللاجئين اليهود"، خلال مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين. وأوصت الوثيقة بوجوب "تكريس مصطلح "اللجوء المزدوج" في المفردات الدولية المستخدمة. ورأت أن هناك مصلحة إسرائيلية في تأسيس رابط بين "مأساة اللاجئين اليهود" و"قضية اللاجئين الفلسطينيين"، مشددة على ضرورة طرح المسألتين ككتلة واحدة في المفاوضات حول اللاجئين في إطار الحل الدائم. كذلك أوصت الوثيقة بألا تكتفي تل أبيب بالمطالبة بتعويضات شخصية للاجئين اليهود من أصل عربي، بل أن تطالب بتعويض "لدولة إسرائيل التي أنفقت موارد في سبيل استيعابهم خلال الخمسينات والستينات". ودعت الوثيقة إلى أن تكون نسبة المطالبة بالتعويضات 2 إلى 3 لمصلحة "اللاجئين اليهود، ليس فقط بسبب عددهم، بل أيضا في ضوء وضعهم الاقتصادي الأفضل إبان تلك الفترة". ووفق المصادر الإسرائيلية فإن عدد "اللاجئين اليهود" من الدول العربية يقدر بـ 865 ألف يهودي وهو أكبر من عدد اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين يقدر عددهم بـ 730 ألف لاجئ فلسطيني ، كما أن الأمم المتحدة قدرت في عام 1951 قيمة الممتلكات الفلسطينية التي استولى عليها اليهود في عام 1948، بما يساوي 150 مليون جنيه إسترليني، بينما تقدر قيمة الممتلكات اليهودية في العراق وحدها بملياري جنيه إسترليني. وسبق لمنظمة "ووجاك""WOJAC" (المنظمة العالمية لليهود المولودين في الأقطار العربية)، التي تأسست في سنة 1975 بجهود اليهودي العراقي مردخاي بن بورات، وهو عضو كنيست ووزير إسرائيلي سابق من حزب "مباي" ولاحقًا من حزب "رافي"، الحصول على دعم مباشر، مادي ومعنوي، من وزارة الخارجية "الإسرائيلية" ومن الوكالة اليهودية. وكانت تستدعي، بين الفينة والأخرى، العديد من السياسيين والباحثين الأكاديميين ذوي الأصول العربية لحضور جلسات هيئتها الإدارية والإسهام في رسم وبلورة سياستها. وأقامت المنظمة فروعا لها في نيويورك ولندن وروما وزيوريخ، كما عقدت مؤتمرات دولية في باريس 1975 ولندن 1982 وواشنطن 1987. وعقدت أربعة مؤتمرات في "إسرائيل". وتوقف عملها عام 1999، بسبب توقف أموال الدعم من طرف وزارة الخارجية الإسرائيلية والوكالة اليهودية. كما نشطت جهود منظمة يهودية أمريكية تعنى بشأن اليهود الذين هاجروا من الدول العربية، وتطلق على نفسها JJAC، حيث ادعت أن عدد "اللاجئين" اليهود يفوق عدد اللاجئين الفلسطينيين، وأن ما تكبده اليهود "اللاجئون" من خسائر يفوق 100 مليار دولار، وأن الأراضي التي كانت بحوزة "اللاجئين" اليهود تفوق مساحة فلسطين ذاتها!. وأخيراً، أعلنت هذه المنظمة أنها تسعى إلى تأسيس صندوق لتمويل حماية المقابر، وإعادة تأهيل الكنس اليهودية وإعادة كتب التوراة الموجودة في بعض الدول العربية، بالإضافة إلى توفير منح دراسية لدارسة الوجود اليهودي في الدول العربية. ومما لا بد من ذكره أن الوثائق الرسمية الصهيونية ذاتها تؤكد أنه لم تكن هناك مشكلة لاجئين يهود. فالوثائق الصهيونية تؤكد أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأول ديفيد بن غوريون هو الذي قرر جلب يهود الدول العربية، بعد أن كانت الحركة الصهيونية قد استبعدت جلبهم. وتذكر الوثائق الصهيونية أن مؤسسي الحركة الصهيونية خططوا لإقامة الكيان الصهيوني اعتماداً على اليهود الغربيين فقط، لكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ومع كل ما حصل لليهود إبان الحرب وخلالها، شعرت الحركة الصهيونية أنها تحتاج إلى تهجير اليهود في الدول العربية من أجل تحسين الثقل الديموغرافي لليهود في مواجهة الثقل الديموغرافي للفلسطينيين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أمر بن غوريون بإرسال بعثات من المستشرقين اليهود للدول العربية التي يوجد فيها اليهود لجمع معلومات عنهم، ثم الشروع في محاولات إقناعهم بالهجرة. وعندما تبين لبن غوريون أن هذه البعثات لم تحقق النجاحات التي كان يأمل في تحقيقها، أمر جهاز الموساد بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الوجود اليهودي في العالم العربي، مثل تفخيخ وتفجير المعابد واغتيال الشخصيات اليهودية النافذة من أجل بث الفزع في نفوس اليهود ودفعهم للفرار إلى لكيان الصهيوني. ويضاف إلى ما سبق نشاط المنظمات الصهيونية في أوساط يهود البلاد العربية وتنفيذ سياسة ركائزها هي: الترغيب والترهيب والتغرير وفبركة "مسألة يهودية". وأسمتهم قادمين جدد واحتفلت بهجرتهم. ولعل الأمر المهم جداً هو أن يهود الدول العربية في "إسرائيل" لا يستحقون صفة لاجئين فقد أصبحوا محتلين نهبوا ممتلكات الفلسطينيين الذين طردتهم العصابات الصهيونية المسلحة، وتنكرت غالبيتهم العظمى لبلدان المولد من جهة ومن جهة أخرى شكك قادة الحركة الصهيونية بيهوديتهم وولائهم للصهيونية. ولذلك كانوا وما زالوا مواطنين من الدرجة الثانية في إسرائيل يعانون أشكالاً عدة من التمييز والهوان السياسي والاجتماعي والاقتصادي في التجمع اليهودي الاستيطاني في"إسرائيل" الذي يرتكز ـ حسب التصنيفات الإسرائيلية ـ أساساً على ثلاث مجموعات، وذلك على النحو الآتي: أ- اليهود الذين ولدوا عاشوا في البلاد قبل قيام الدولة وسموا التسبار أي الصبار. ب- اليهود الذين قدموا من دول أوروبا وسموا الأشكيناز. ت- اليهود الذين هاجروا من الدول العربية و الإسلامية، أي من شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأطلق عليهم لقب "المزراحيم" أي الشرقيين. و"المزراحيم" مصطلحٌ عبريّ جامع يُستخدم للتعريف باليهود الشرقيين الذي كانوا يعيشون في البلاد العربية، وفي بلادٍ أغلبيةُ سكّانها مسلمون. وأصلُ المفردة هو "زرح" بمعنى "أشرق"،وهو مصطلحٌ يُطلق عليهم؛ ولكنّ كلّ قسمٍ منهم يعرِّف نفسَه بالبلاد التي أتى منها أصلاً: يهودي ـ مغربي، يهودي ـ جزائري، يهودي ـ سوري، الخ. وإذا كانت "زرَحَ" تعني أشْرَقَ، فـ "مِزْراح" تعني شرق، أما "زْرِيحَة" فتعني شروق. ومصدر المصطلح الذي أطلقتْه المؤسّسةُ الصهيونيةُ هو "عدوت ها ــ مزراح" (الطوائف الشرقية)، وكانت كنايةً مهينة. وتُضاف مجموعة رابعة يمثلها اليهود الروس الذين هاجروا إلى "إسرائيل" في بداية تسعينات من القرن الماضي. ووفقاً للمصادر الإسرائيلية فإنه " نتيجة لتحقيق الاستقلال السياسي توافدت إلى البلاد أعداد هائلة من القادمين الجدد فتضاعف عدد السكان اليهود خلال السنوات الأربع الأولى من قيام الدولة (1948-1952) من 650 ألف نسمة إلى 1300000 نسمة، الأمر الذي أدى إلى تغيير مبنى المجتمع الإسرائيلي وتركيبه. وأسفر هذا الأمر عن تكوين اجتماعي يعتمد على مجموعتين رئيستين: أغلبية تضم بدرجة رئيسة المواطنين اليهود القدامى والقادمين الجدد الذين نجوا من براثن النازية في أوروبا، وأقلية كبيرة تضم القادمين الجدد من يهود الدول الإسلامية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتراجعت نسبة اليهود الشرقيين إلى مجموع سكان"إسرائيل" بحسب البلد الأصلي من 42,3% عام 1961 إلى 36,3% عام 1993,اما بحسب مكان الولادة فقد ازدادت من 14,9 %عام 1961 إلى 22,6% عام 1993. ومن حيث النسبة الإجمالية واستنادا إلى إحصائيات عام 1993 كان اليهود الشرقيون يشكلون نسبة 36,3%أي نحو 1.573.900 نسمة من نحو 4.335.2 مليون نسمة. وهي نسبة قابلة للازدياد لدى إضافة عدد اليهود الشرقيين وأبنائهم الذين ولدوا في فلسطين. ورقمياً، أفادت معطيات نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بمناسبة الذكرى الـ 63 لتأسيس إسرائيل، أي العام 2011، أن عدد سكان إسرائيل بلغ 7 ملايين و746 ألف نسمة بينهم 75.3% من اليهود 20,5% من العرب وضمنهم سكان القدس الشرقية والقرى العربية السورية في هضبة الجولان. وعانى اليهود الشرقيون من الأمراض الاجتماعية والأخلاقية، وأصبح العنف والإجرام والجهل والتخلف، وغيرهما من الأمراض الاجتماعية، مرادفات ملازمة لهم. وأصبح هذا الواقع الأليم كالشوكة في حلوقهم أمام ذكرياتهم الطيبة عن حياتهم السابقة في وطنهم الأول. وبالفعل أحدثت مثل هذه التجارب الأليمة العديد من الآثار السلبية، منها ما يلي: 1- خلاص زائف وانتحار جماعي: لم تكن موجات الهجرة الجماعية لليهود السفارديم إلى إسرائيل أرض الميعاد، كما يحلو لهم أن يصفوها، إلا عملية انتحار جماعي لأبناء هذه الطوائف، فقدوا خلالها كل نفيس وغال ، عندما تحطمت آمالهم وأحلامهم على صخرة الواقع الإسرائيلي المرير في المعسكرات الانتقالية وفي مدن التطوير. 2- هجرة عكسية: أمام هذه الأوضاع القاسية، كان من الطبيعي أن تحدث هجرة عكسية من قبل السفارديم والشرقيين عن الكيان الصهيوني، خاصة مع إعلان بعض الحكومات العربية (مثل المغرب في سبعينات القرن العشرين) عن ترحيبها بعودة أبنائها من اليهود، مما مثل دافعا لخروجهم من الجحيم الصهيوني. وهناك خلافان بين اليهود الشرقيين وبين اليهود ذوي الأصول الأوروبية. الخلاف الأول يكمن في المستوى الفكري؛ فعلى مستوى المعتقدات ترتبط معظم المجتمعات الغربية التي أتى منها اليهود الإشكيناز بتراث علماني وبثقافة لا دينية هي نتاج ثورات اجتماعية شاملة حيث نجح المجتمع الأوروبي في تجاوز مجتمعاته القديمة والمعتقدات السائدة بها، على عكس الحال في المجتمعات الشرقية التي تحتفظ بتراث ديني وتاريخي يرتبط بالطابع التراكمي للثقافة في تلك المجتمعات التي احتفظت بالكثير من ميراثها الإنساني والتي قلما عرفت تغيرات جذرية على مستوى الوعي العام والأفكار السائدة بها. الخلاف الثاني يكمن في مستوى التعلم والتأهيل المهني والقدرة على التعامل مع سوق عمل متطور حيث يرتبط مستوى التأهيل المهني للإشكناز بمستوى تطور الاقتصاد الأوروبي في حين يحتفظ السفارديم بالسمات المتواضعة لسوق العمل في الجنوب. ومنذ العام 1948 طرأت متغيرات كثيرة على خريطة الانتشار أو التوزع الديمغرافي ليهود البلاد العربية والإسلامية في هذه الدولة، وفيما يلي عرض لأوضاع يهود كل بلد عربي فيها على حدة، وإيران وتركيا وأثيوبيا وتوزعهم وأنشطتهم. يهود سوريا تعتبر نسبة الولادات مرتفعة بالنسبة إليهم شأنهم شأن بقية اليهود الشرقيين، في الوقت الذي يعتبر اتجاههم نحو الاندماج في المجموعات الأخرى جيدة بالنسبة للمجموعات الشرقية الأخرى. فقد انخفضت نسبة الزواج ضمن المجموعة نفسها عند اليهود السوريين واللبنانيين من 39% عام 1952 إلى 29% عام 1962. وليهود الشام وحلب كنس خاصة في القدس وتل أبيب وحيفا، وهم معروفون بتراتيلهم وأغانيهم الدينية الخاصة التي تعرف باسم "الباكشوت" والتي تستخدم فيها الألحان العربية (تغنى على نسق الموشحات والقدود الحلبية). وهم بارزون في النشاطات الدينية العامة وخصوصاً الحلبيون، إذ أن العديد من الحاخامات السفارديم في القدس هم من أصل حلبي. وأبناء هذه المجموعة نشيطون في مجال التجارة والصرافة، ووجودهم ضئيل في الكيبوتسات والموشافات أو الموشافوت، التي ذهبوا إليها. وكان يهود حلب يأتون للإقامة في القدس بدوافع دينية قبل الاستيطان اليهودي الحديث في فلسطين حيث كان أغلبهم من الحاخامات. لليهود السوريين واللبنانيين وجود في مختلف المستويات السياسية في "إسرائيل"، فبعضهم كان عضواً في الكنيست مثل: مناحيم باديد وأبراهام عباس. ويعتبر "موشي ساسون" سفير إسرائيل الأسبق في مصر ووالده الياهو ساسون وزير البريد والشرطة سابقاً، من أبرز الشخصيات السياسية في هذه المجموعة. ويذكر أن إلياهو ساسون من مواليد دمشق سنة 1902، هاجر في العام 1920 واستوطن فلسطين. شغل منصب مدير القسم العربي في الدائرة السياسية التابعة للوكالة اليهودية قبل قيام "إسرائيل"، ثم مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية. واكتسب إلياهو ساسون، خبرة واسعة في التعامل مع النخب العربية. ومع أن السلام كان آخر شيء تفكر فيه "إسرائيل"، فإن إلياهو ساسون كان يتحدث مع النخب العربية كثيراً ومطولاً عن السلام ويتغنى به، من دون أن يحدد أسسه ومضامينه، ويعزف على مقولة "التعاون العربي ـ اليهودي" في مختلف المجالات، مدركاً إن لهذه المصطلحات الوقع المؤثر. وتذكر استر شطينهورن حلواني في كتابها "دمشق مدينتي". وهو عبارة عن كتاب مذكرات الكاتبة الشامية الدمشقية، مدينة دمشق الشام، تاريخها، مناظرها، يهودها، أعياد اليهود، التربية والثقافة عندهم، أعمالهم وأشغالهم، المسكن، حياة الشبيبة، فترة الهجرة والنزوح من دمشق خفية، القدوم إلى "إسرائيل"، استيعاب العائلات هنا، أسبوع لدى جالية دمشق، تراجع الجالية ونهاية المطاف ليهود سوريا. وتقول الكاتبة في مقدمتها لم اسمع أي خطاب سياسي في "إسرائيل" يتحدث عن بقايا طائفة كانت هناك حتى قيام الدولة، طائفة كبيرة تطفح بالحياة، النشاط الفكري والثقافي، هذه الطائفة لم تُبد لم يُقض عليها، بالعكس فان هذه الطائفة طبّقت فقرة ،عودة الأبناء إلى وطنهم، كانت دمشق الشام ملجأ ليهود الديار المقدسة الذين فروا من ملاحقة الصليبيين، الأمراض، الأوبئة، فقد استوطن في هذه المدينة كهنة معروفون أقاموا المدارس الدينية وكانت علاقتهم مع ديارهم وثيقة. والشام كانت ملجأ للهاربين من محاكم التفتيش في اسبانيا وللهاربين من يهود بلاد فارس، تركيا، وبلدان أخرى. يهود العراق يأتي يهود العراق في المرتبة الخامسة من حيث الحجم بين المجموعات الإثنية الموجودة في"إسرائيل" بعد اليهود المغاربة والبولونيين، والروس والرومانيين، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 1985، حسب المجموعة الإحصائية الإسرائيلية 267800 شخص. منهم نحو 97 ألف شخص من مواليد العراق و170800 شخص ولدوا في إسرائيل لآباء يهود عراقيين. وقد وجد يهود العراق صعوبات كبيرة جداً حيث وجدوا أنفسهم في بيئة اجتماعية مختلفة جداً، عن حياتهم السابقة التي عاشوها في العراق. وكانت اللغة الجديدة المفروضة عليهم واختلاف أنماط العمل، وصعوبات السكن والعيش في المعابر مدة طويلة، أهم المشاكل التي واجهوها. وزاد من مأساوية أوضاعهم في السنوات الأولى رؤيتهم لأبنائهم وبناتهم يساقون قسراً للخدمة في الجيش الصهيوني. أما بالنسبة للاستيطان فقد تم توجيه أغلبية المهاجرين من يهود العراق إلى مدن التطوير، وإلى المستوطنات الزراعية الجديدة، حيث وجد القسم الذي كان يعيش منهم في بغداد والمدن العراقية الكبيرة الأخرى نفسه مضطراً للتكيف مع حياة القرى الزراعية. أما الذين كانوا يعيشون في القرى الشمالية (ومعظمهم من اليهود الأكراد) فلم يكن الأمر صعباً بالنسبة إليهم لتشابه نمط معيشتهم السابق مع وضعهم الجديد في "إسرائيل". وكان في صفوف يهود العراق نخبة متعلمة تضم أعداداً كبيرة من المختصين. فقد كان بينهم ألف مدرس، وأكثر من مئة طبيب، وعدد لا بأس به من المحامين والمهندسين والصحفيين. وعليه فقد احتل هؤلاء المركز الأول بين اليهود الشرقيين سواء من حيث أوضاعهم الاقتصادية أو من حيث تقدمهم السياسي. وشكل يهود العراق الطاقم الأساسي في الصحافة والإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية، واحتلوا مراكز هامة في الدائرة العربية بالحكومة الإسرائيلية، كما برزوا في الهستدروت، والتجارة والبنوك، وكان الطلبة منهم يشكلون العدد الأكبر من طلبة اليهود الشرقيين بمن فيهم يهود البلاد العربية في الجامعة العبرية، والجامعات الإسرائيلية الأخرى. وشكل يهود العراق في السنوات الأولى لقدومهم مجموعة متقوقعة حول نفسها، حيث كانت نسبة الزواج داخل مجموعة يهود العراق عام 1952، أعلى نسبة بين كل المجموعات الموجودة داخل إسرائيل وبلغت 92%. ثم أخذت هذه النسبة في التناقص تدريجياً حتى بلغت 70% عام 1962، وظلت على الرغم من هذا التناقص من أعلى النسب في ذلك العام. وبرز من اليهود العراقيين بين النخب السياسية والعسكرية كل من: شلومو هيلل رئيس الكنيست الأسبق، وموشي شاحال وزير مالية سابق والرجل الثاني في الحزب الليبرالي، ووشوشانا أربيلي الموزلينو وزيرة الصحة سابقاً ومن قادة حزب العمل، ومردخاي بن بورات رئيس حركة تيلم وعضو كنست سابق. وعضوا الكنيست ران كوهين و رعنان كوهين، وإيلانا كوهين عضو كنيست من عام 2003. يهود مصر حسب إحصائيات إسرائيلية تعود للعام 1986، وجد نحو 65 ألف يهودي مصري وسوداني في إسرائيل عام 1985 منهم 28 ألفاً من المهاجرين و37 ألفاً ولدوا في إسرائيل. ولقد استوطن قسم قليل منهم في المستوطنات الزراعية والكيبوتسات، فيما استوطن القسم الأكبر منهم في مدينة حولون، وبات يام الاستيطانيتين في منطقة تل أبيب، وفي مدينة عكا، وفي مستوطنة كريات حاييم بمنطقة حاييم بمنطقة حيفا، وفي مدينة بئر السبع. وبسبب من طبيعة النمط السابق لحياتهم –مدنيون في معظمهم- ومستواهم التعليمي الجيد ومهاراتهم في معرفة اللغات الأجنبية، وما يعرف من المصريين من حسن تعامل فقد برزوا في مجال السياحة والفنادق والمصارف والخدمات المدنية. كما يوجد عدد منهم في الصناعات الجوية. يهود اليمن قدرت المجموعة الإحصائية الإسرائيلية لعام 1986 وجود 49500 يهودي من مواليد اليمن، إضافة إلى 161100 يهودي ولدوا في"إسرائيل" لآباء يمنيين. ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء نحو 35 ألف يمني ممن تعتبرهم الإحصاءات الصهيونية من أصل إسرائيلي (الذين وُلِدَ آباؤهم في "إسرائيل" مهما كانت أصولهم الإثنية)، فالمجموعة اليهودية اليمنية كانت المجموعة اليهودية الشرقية الوحيدة ذات الحجم المعتبر عند قيام إسرائيل عام 1948، نحو 35 ألف يهودي يمني. وقد استوطن ثلث اليهود اليمنيين في المدن، وخصوصاً في الأحياء الضيقة مثل حي المصرارة في القدس وحي كفار شاليم في تل أبيب الذين يشكل اليهود اليمنيون غالبية السكان فيهما. ويعمل هؤلاء المقيمون في المدن في البناء، وفي الأعمال والحرف اليدوية، وفي قطاعي التعليم والخدمات. كما استوطن عدد كبير من اليهود اليمنيين في مدن التطوير في الجليل والنقب، وفي المستوطنات الزراعية. وفي عام 1969 كان هناك 40 موشافاً مسكوناً بالكامل تقريباً باليهود اليمنيين. وواجه يهود اليمن في سنوات هجرتهم الأولى صعوبات تأقلم كبيرة جداً بسبب من الفوارق والاختلافات الثقافية وخاصة من اليهود "الإشكناز" الغربيين. وكانت مهنهم ولباسهم، وأمزجتهم وطريقتهم في الحياة غريبة كلياً عن حياة هذا الكيان. وكانت الحدادة حرفتهم الأساسية، وكذلك صناعة الأحذية والجلود التي تقوم على طرق بدائية لا تجد لها طريقاً في الكيان الصهيوني. وقد ظلوا يعملون في زخرفة النحاس وصناعة المطرزات وكتابة الرقائق التي لم تكن لتجد لها سوقاً في البداية، ولكن الصهاينة الذين أخذوا فيما بعد يتطلعون لاصطناع "تراث إسرائيلي خاص" بدأوا الاهتمام بها، وبالتقاليد اليمنية الخاصة في اللباس والغناء والألحان الجماعية لتوظيفها في الحديث عن "الفلكلور الإسرائيلي" المزعوم. يهود ليبيا خلافاً لبقية المجموعات اليهودية التي وصلت إلى إسرائيل من الدول العربية، وخصوصاً العراق وسورية والمغرب واليمن، فإن الليبيين اندمجوا بشكل كبير في المجتمع الإسرائيلي وليس من السهل التمييز بينهم وبين الآخرين. مناطق سكنهم غير محصورة في بلدة أو منطقة معينة، أو في المركز والشمال، وفي تل أبيب وحيفا ونتانيا.. لا تجمعهم أحياء معينة أو مبان خاصة بل يندمجون في شكل متكامل مع بقية اليهود. وخلافاً للآخرين القادمين من الدول العربية، فقد حرصوا على الحفاظ على كل ما يملكونه فأقاموا متحفاً خاصاً بهم يشرح تاريخهم ويعرضون فيه الصور من داخل ليبيا في خمسينات وستينات القرن العشرين، وكذلك الملابس والمعدات التي تعكس عاداتهم وتقاليدهم. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتهم عند وصولهم إلى "إسرائيل"، فقد تمكنوا أكثر من غيرهم، من الاستقرار والعمل وأقاموا 18 تجمعاً سكانياً واندمجوا في التعليم وعينوا مديرين ومعلمين وسيطروا على مواقع كثيرة في مختلف المهن، في الصناعة والتجارة والسياحة، وأيضاً في السياسة إذ تبوأ الكثير منهم مناصب مهمة في الكنيست والسلطات المحلية. وأقاموا منظمة خاصة بهم أطلقوا عليها "المنظمة الدولية من أجل يهود ليبيا". وأنشأ يهود ليبيا أكثر من مركز أبحاث، وكما بقية اليهود القادمين من الدول العربية، حرصوا على مواصلة احتفالاتهم الدينية والاجتماعية بالنمط نفسه الذي اعتادوه في ليبيا، وهم بذلك يشبهون يهود المغرب خصوصاً في احتفالاتهم المعروفة بـ"ليلة النوار" وهي الليلة الأخيرة في عيد الفصح والمعروفة بـ"الميمونة". وبرز منهم، موشيه كحلون- وزير الاتصالات الذي ولد العام 1960، وانتخب في الكنيست السادس عشر. وحاز على المكان الأول في الانتخابات الداخلية في الليكود العام 2006. ويعد أبرز الوجوه الشرقية في الليكود. يهود تونس يُقدّر عدد يهود تونس في "إسرائيل" بنحو 50 ألف يهودي من أصول تونسية يقيمون في مناطق وقرى داخل"إسرائيل" وهم يمثلون حالة اجتماعية وثقافية داخل المجتمع الإسرائيلي حيث يحافظون على نفس عادات وتقاليد أبائهم وأجدادهم التونسيين، فيأكلون "الكسكسي" ويقيمون "الحضرة" ويشربون الشاي الأخضر ويستمعون إلى "المالوف" الأندلسي والموسيقى التونسية الأصيلة. وقد برز في الوسط السياسي شخصيتان من يهود تونس هما: سيلفان شالوم، وزير التطوير الإقليمي في حكومة نتنياهو الثانية، وعضو الكنيست دافيد طل. يهود المغرب يشكل يهود المغرب في "إسرائيل" ثاني أكبر جالية بعد الجالية اليهودية الروسية, والذين يقدر عددهم بمليون مواطن إسرائيلي يحتفظون بالجنسية المغربية ويزورون المغرب باستمرار, ولا يزالون يحافظون على التقاليد والعادات المغربية ويعتبرون ملك المغرب ملكا عليهم ويحترمونه وبعد رحيل الملك الحسن الثاني أعطوا لست ميادين اسم ميدان الحسن الثاني في"إسرائيل". ولا تشكل مجموعة يهود المغرب العربي المجموعة الأكبر عدداً في إسرائيل فحسب، بل والمجموعة الأكثر فتوة ونشاطاً من الناحية الديمغرافية فمتوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة من هذه الأقطار هو 5 أشخاص، في حين يبلغ عدد بعض الأسر منها 10-12فرداً. أما من الناحية الاجتماعية فقد جاء المهاجرون من أبناء هذه المجموعة وخصوصاً الذين جاؤوا في الخمسينات وأوائل الستينات، دون صفوة سياسية أو اقتصادية. فالنخبة المالية المدنية المثقفة من يهود هذه الأقطار والتي كانت مندمجة في إطار النخبة الفرنسية المثقفة، هاجرت إلى فرنسا، تاركة الجماهير اليهودية الأكثر فقراً وبؤساً، الأمية في معظمها، تذهب إلى إسرائيل. أما من الناحية الاستيطانية فإن معظم مهاجري المغرب قد وجهوا إلى المستوطنات والكيبوتسات الجديدة التي بنيت في الخمسينات والستينات، وإلى مدن التطوير مثل: بيسان (يشكل يهود المغرب نصف سكانها)، ومجدال هاعيمك (يشكل يهود المغرب ثلثي سكانها)، وعسقلان، واسدود، وحتسور (رؤساء بلدياتها من يهود المغرب)، وكذلك بئر السبع، وأوفاكيم، ومتسفي رمون، وسديروت، وأور يهودا، وكريات ملاخي وغيرها. ويسكن يهود المغرب مع بقية اليهود الشرقيين في المدن الكبرى ضمن أحياء ضيقة بوجه عام، مثل وادي الصليب في حيفا، وأحياء: هاتكفا، ولفي تساهل، وكفار شاليم في تل أبيب، والمصرارة في القدس. ومن الشخصيات السياسية البارزة من يهود المغرب الوزراء: دافيد ليفي، وعمير بيرتس، ومئير شتريت، وشلومو بن عامي، وإيلي سويسا. وأُخضع اليهود الشرقيون بمن فيهم يهود الدول العربية إلى عملية يمكن تسميتها عملية "محو للذاكرة" من أجل تسهيل دمجهم في مجتمعهم الجديد. وكان هؤلاء عقب وصولهم إلى "إسرائيل" ينقلون إلى مخيمات مؤقتة حيث تبدأ عملية "تأهيلهم القسري" وقد جرى لتوطين المهاجرين الشرقيين توزيع على الضواحي وفي المستوطنات التي أنشئت بعيداً عن المدن الكبيرة لاسيما في الجليل وعلى طول الحدود الشرقية. وكل ما قدمته لهم الحكومة الإسرائيلية هو إلحاقهم بما يسمى أعمال الطوارئ "عفودات دحق" وهي أعمال شاقة مهينة، فضلاً عن أنها مؤقتة، مثل العمل في خدمات الطرق من تعبيد ورصف، وتقطيع الأخشاب والصخور، وغيرها من الأعمال الجسدية الشاقة المرهقة، التي لا تمكنهم من العيش حياة كريمة. ويمثل فشل تجارب الاستيعاب في فشل الصهيونية الذي أجمله الكاتب الإسرائيلي موردخاي بر أون بقوله: "لقد كانت الحركة الصهيونية تطمح في إقامة مجتمع نموذجي... والآن، وبعد مرور ثمانين عاما على كتابة هرتزل لكتاب دولة اليهود، ونحو ثلاثين عاماً على إقامة الدولة، ننظر حولنا، ونرى أننا لسنا على الإطلاق مجتمعاً نموذجياً. لقد كان التطلع لحل مشكلة الطوائف جزءاً لا يتجزأ من الفكر الصهيوني. والفشل في هذا المجال هو، في واقع الأمر يمثل فشلاً في تحقيق الصهيونية، فالحلم الصهيوني كان يطمح في تجمع إقليمي لليهود في فلسطين كشعب واحد - وليس لتجميع إقليمي لقبائل مختلفة، لا تلبث عند وصولها أن تتصارع مع بعضها البعض". وتسود في هذا المجتمع الصهيوني, شائعات وخرافات بالنسبة لأبناء الطوائف الشرقية ومكانتهم السياسية في السياسية الإسرائيلية حددها الباحث سامي سموحا بالخرافات التالية: "الخرافة الأولى تتمثل في أن الطائفة آخذة في الضعف وأن مشاعر الحرمان الطائفية آخذة بالتلاشي. والخرافة الثانية هي عدم وجود ظلم طائفي. والخرافة الثالثة هي وجود تحالف إيديولوجي بين الشرقيين والليكود الذي يقوم بجذبهم ليس فقط كخصم "العمل" الذين يكرهونه وإنما أيضا كمعبر عن طموحاتهم الوطنية وتقاليدهم الدينية والتزامهم بفكرة إسرائيل. وتتمثل الخرافة الرابعة في القول بانتهاء العصر الاشكنازي في السياسة الإسرائيلية". وفيما عدا الخطاب القومي، فإن نموذج الاحتواء والإقصاء الذي تتبعه الهيمنة لا يستطيع أن يصف بدقة اللقاءات في الحيز المحلي وفي الحياة اليومية، تلك اللقاءات التي فرضت على أناس غير مخولين، أو ليسوا في موقع المسؤولية عن اتخاذ القرارات. علاوة على ذلك فإن نموذج الاحتواء والإقصاء يرمز إلى علاقة ثنائية بين الحاكم الفعال (الإيجابي) وبين المحكوم السلبي، بواسطة الغرباء الحاكم بالنير أو الرسن المشدود على عنق المحكوم ويشده إلى الخلف والأمام، يقرب ويبعد، يشد ويرخي، يحتوي حتى يستخدم ويقسو حتى يعرف نفسه كنقيضه الإيجابي. وفي المقابل يمكن القول إن تواجد الغرباء يحول "المحليين" إلى عناصر في نظر أنفسهم، يتعرضون إلى عملية إقصاء، تغريب، بواسطة الغرباء. أشكال التمييز ثمة معطيات كثيرة تشهد على حالة التمييز والتهميش التي يتعرض لها الشرقيون في المجتمع الإسرائيلي. ويصوِّر تجمع الفئات الإثنية اليهودية في إسرائيل في كثير من الآداب الإسرائيلية بلغة صورية وخيالية على أنه "جمع المشردين" أو "عودة أولاد "إسرائيل" إلى وطن التوراة". وتحت شعار "شعب واحد". وهذه العبارات اللغوية تثير التصور وكأن تجمع هذه الفئات الإثنية ما هو إلا تجدد اللقاء، وتجمع من تشردوا لأسباب تاريخية عبر العالم فوق وطن قومي يقوم على أساس الوحدة والمساواة بين كل اليهود، وبدون إعطاء الفوارق الإثنية أي اعتبار. لكن الحقيقة تبقى بعيدة جداً عن الصور اللغوية، فقضية انضمام اليهود الشرقيين إلى مجتمع الدولة اليهودية، واستيعابهم في هذا المجتمع قد تعامل معها أصحاب القرار، والقيادة السياسية، والمسؤولون عن قضايا الاستيطان (وكلهم إشكنازيم) على أنها مواجهة مع حالة من التخلف الحضاري، مواجهة الحداثة والتطور الاشكنازي والبدائية والتقليدية السفارادية. لقد كانت ردود الفعل لدى الاشكنازيم، ومنذ وصول السفاراديم تعكس نظرة الاستعلاء والازدراء تجاه السفارديم، حيث نظروا إليهم على أنهم "أجيال الصحراء". وإن الاشكنازيم كمبادرين لفكرة إقامة الدولة اليهودية وحاملين لها، فرضوا ادعاءهم بأن لهم الحق بمطالبة السفارديم بالتأقلم في المجتمع (الاشكنازي) القائم الذي استوعبهم، بما معناه التخلص من أسلوب حياتهم وعاداتهم التقليدية "السلبية" ومن النماذج الحضارية "المتخلفة". ويُعتقد أن الاضطهاد الذي مورس وما زال يمارس على اليهود الشرقيين، وبالتالي استمرار مكانتهم الاجتماعية المتدنية قد أسقط شعار وأسطورة "الشعب الواحد". فالحديث عن المساواة وتكافئ الفرص خلف الحدود الإثنية مع مرور الأجيال على أنه خداع وليس له أية مصداقية على أرض الواقع. و إن حجم الروابط بين الطبقة الاقتصادية والمواصفة الإثنية له أهمية بالغة، في المجتمع الإسرائيلي. إضافة لذلك فإن الانتماء الإثني يشكل عاملاً مهماً في هيكل التنظيم الاجتماعي في المجتمع الإسرائيلي. وأن للزواج في المجتمع الإسرائيلي اليهودي طابعاً إثنياً متجانساً (Homogen). ففي حين كانت نسبة الزواج المختلط بين الاشكنازيم السفارديم العام (1955) 11.8%، فقد وصلت بعد ثلاثين عاماُ (1985) إلى 23%. و من بين 11860 حالة زواج لرجال سفارديم العام (1985) كان 82.6% زواجاً متجانساً إثنياً, وفقط 17.4% غير متجانس إثنياً (Heterogen). وعلى الجانب الاشكنازي كان هناك وبنفس العام 6985 حالة زواج لرجال إشكناز، منها 67.3% زواج متجانس إثنياً و32.7% غير متجانس. هذا يدل بوضوح على أن الزواج بين اليهود ذو طابع إثني. وتشير الدراسات التي اهتمت بقضية العلاقات بين الجماعات الاجتماعية في إسرائيل إلى ارتفاع درجة الاختلاط بين المهاجرين اليهود الذين ينتمون إلى نفس البلد، وانخفاضها بين اليهود الذين ينتمون إلى بلاد مختلفة. فقد آثر المهاجرون إلى إسرائيل منذ البداية البقاء مع أبناء البلاد التي قدموا منها. وكانت مسألة إسكان المهاجرين اليهود من أصعب الأمور التي واجهتها إسرائيل منذ مراحل استيعاب المهاجرين الأولى عقب قيام الدولة. وتظهر الفجوة في مجال السكن، في مؤشرات عدة ففي سنة 1992 كانت الكثافة السكانية لدى مواليد آسيا وأفريقيا 1.11 فرد للغرفة في مقابل 0.91 لدى مواليد أوروبا وأمريكا. ومن الجدير ذكره، أن الأحياء الفقيرة في المدن تعتبر بؤراً لسخط أبناء الطوائف الشرقية أكثر مما هو عليه الحال في قرى التطوير أو المستوطنات الزراعية. ذلك أن هذه الأحياء تقع بالقرب من الضواحي الغنية والجميلة التي تستوعب المهاجرين الغربيين الجدد، فيبدو التناقض واضحاً: أحياء تكاد تكون معتمة يسكنها اليهود الشرقيون وأحياء تعج بالأضواء من نصيب اليهود الغربيين. ذلك أن أكثر ما يشكو منه الشرقيون هو أن المهاجرين الجدد القادمين من الغرب يحصلون على مساكن حكومية فور وصولهم إلى إسرائيل، في حين أن يهود المغرب مثلاً ما زالوا يعيشون في الأحياء الفقيرة منذ سنوات. وتتمتع بأولوية أكثر في اهتمام الحركات الرافضة التي تعبر عن مطالب اليهود الشرقيين، وهو ما يعكسه أول منشور صدر عن الفهود السود في 2/3/ 1971، فورد فيه: " كفى بطالة، كفى لنوم عشرة في كل غرفة، كفى أن نرى بيوتاً تبنى للمهاجرين الجدد". وواجه أبناء المهاجرين من اليهود الشرقيين صعوبات كبيرة في الاندماج مع المنهج التعليمي الإسرائيلي الذي يعتمد الطرق والمعايير الأوروبية التي وضعها مؤسسو الدولة من الأشكناز، والذي كان هدفه خلق مجتمع جديد على الطراز الاشتراكي بخلاف المجتمع التقليدي الذي عرفه الشرقيون. ويضاف إلى ذلك أن أبناء الشرقيين ينتمون إلى عائلات كثيرة الأولاد ذات مستوى اقتصادي متدن، الأمر الذي جمع بين الفقر والتخلف، وجعل المدرسة وحدها مسؤولة عن تعليم هؤلاء الأبناء وتوجيه تقدمهم الدراسي. أما فيما يتعلق بنسبة الطلاب الشرقيين إلى الغربيين وعددهم فتؤكد الأرقام حجم الفارق الهائل لصالح الغربيين، وكل المعطيات تشير إلى استمرارية الفجوة، بل ربما إلى استحالة تجاوزها سواء أكان ذلك بقرار رسمي أم سياسي، لأنها محصلة تباين طبقي وتمييز متأصل بات صعباً اقتلاعه من جذوره. التمييز الاقتصادي ركزت الأبحاث التي تناولت الفوارق الاقتصادية بين الفئات الإثنية في المجتمع الإسرائيلي، على جانب التوزيع المهني، الذي يرتبط جداً بالمستوى التعليمي للفرد لتفسير التباين الاقتصادي والاجتماعي بين هذه الفئات، وبالتالي كانت النتائج مضللة ومجافية للحقيقة. ذلك أن التوزيع المهني يشكل جانباً واحداً من مكونات الحياة الاقتصادية. فالنشاطات الاقتصادية مرتبطة جداً بالمصالح السياسية، بتوجهات أصحاب رأس المال، بالتطور التكنولوجي، بتجهيز القوى العاملة وثم بشروط السوق. ولقد شكل اليهود الشرقيون قوى عاملة رخيصة ومتنقلة في عملية التطوير، ولعبوا دوراً مركزياً في بعض القطاعات الاقتصادية، فكان لهم الدور الرئيس في توسيع القطاع الزراعي، وتالياً قطاع البناء، وبعد استكمال تطوير هذه القطاعات أخذوا دورهم المهم في تطوير وتوسيع قطاع الصناعة. ونرى بوضوح التباين الإثني في التركيبة المهنية، حيث أن اليهود الشرقيين من الجيل الأول والثاني يتمركزون في الأعمال البروليتارية. والأهم من هذا أن نسبة الجيل الثاني (المولودين في إسرائيل) من السفارديم الذين يمارسون أعمالاً بروليتارية تفوق نسبة الجيل الأول. وإذا ما أخذنا المراتب العليا في الهرم المهني، نرى أن الإشكينازيم (الجيل الأول والثاني) ممثلون في هذه الفئة بشكل أقوى من السفارديم وخاصة (الجيل الثاني). والمثير للانتباه ليس فقط نسبة التمثيل المتدنية عند السفارديم في هذه الفئة، إنما نسبة التراجع عند الجيل الثاني. تبين هذه المطيات أن السفارديم (الجيل الأول والثاني) يتمركزون في المراتب السفلى من الهرم المهني، بينما الإشكنازيم يحتلون المراتب العليا. هذا يعني أن الخط الإثني يمتد عمودياً وأفقياً (مهنياً وإثنياً). وفي العام 1965 كان دخل الأسرة من السفارديم الجيل الأول يساوي 72% من دخل الأسرة الاشكنازية من الجيل نفسه، وارتفع العام 1977 ليساوي 81%. والمثير للانتباه أن هذا الفارق في الدخل السنوي بين الأسرة الاشكنازية والأسرة السفاردية لم ينتقل فقط إلى الجيل الثاني، بل الأهم من هذا أن المدخول السنوي للأسرة السفارادية من الجيل الثاني أقل من مدخول الأسرة في الجيل الأول، بينما الحال عند الأسرة الاشكنازية-الجيل الثاني-هو العكس تماماً. إجمالاً، إن اختراع "قضية اللاجئين" اليهود من الدول العربية، وقبل ذلك اختراع ما يسمى "الشعب اليهودي" أو "شعب الله المختار" أو"الأمة" أو"القومية اليهودية"، واختراع "أرض الميعاد" ورزمة الأساطير والخرافات المؤسسة للكيان الصهيوني هو دليل إفلاس الفكر السياسي "الإسرائيلي" الذي ما انفك عن إصدار براءات اختراع لأوهام وأضاليل محورها توظيف واستخدام بائس للدين اليهودي وتحويل أتباعه إلى عبيد أو عمال سخرة في أحسن الأحوال لخدمة طغمة سياسية ذات تلاوين علمانية ومتدينة، كان قادة أجيالها المتعاقبة لا يتوانون عن شن الحروب ضد اليهود المناوئين للصهيونية بحجة أنهم يهود يكرهون أنفسهم.
|
||||||