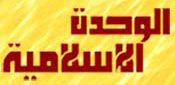|
|||||||
|
يمثل كتاب ميزان العمل لأبي حامد الغزالي الجانب الخلقي من فلسفته، وذلك لما تضمنه من قضايا إسلامية. مع أنه كان قد تطرق إلى هذا الموضوع في كتاب أحياء علوم الدين، إلا أن ميزان العمل جاء أكثر شمولا وتفصيلا في بحث المسائل الأخلاقية، ومن هنا، يجدر بنا اعتباره المصدر الرئيسي لفكره الأخلاقي. وتدور فصول الكتاب حول الفصول التالية: سبيل السعادة، قوى النفس، الطريق إلى تهذيب الأخلاق، أمهات الفضائل، أنواع الخيرات أو السعادات، وبيان علامة السائرين إلى الله تعالى. يتميز هذا الكتاب بأنه يؤلف بين ثلاثة مصادر ثقافية كبرى هي : المصدر الفلسفي المستمد من الفكر الفلسفي اليوناني أولاً، والتراث الصوفي الإسلامي المستمد من الكشف الصوفي عند الجنيد خصوصاً ثانياً، والدين الإسلامي المستمد من القرآن الكريم والحديث ثالثاً. وهكذا، فالكاتب نموذج فذ للفكر الأخلاقي الإسلامي في أدق معانيه. قبل البدء في استعراض الكتاب، سنبين كيف استطاع الغزالي أن يجمع بين المصادر الثقافية الثلاثة الآنفة الذكر. ولنأخذ مثلاً قوى النفس الثلاث والفضائل المقترنة بها وهي: القوة الناطقة وفضيلتها الحكمة، والقوة الغضبية وفضيلتها الشجاعة، والقوة الشهوانية وفضيلتها العفة. فهذا التقسيم يرقى إلى أفلاطون والفكر العربي الذي تأثر به. يجد الغزالي أن لهذه القوى نظائر في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾(الحجرات:15). فالإيمان بالعلم اليقيني هو فضيلة القوة الناطقة، والمجاهدة بالأموال دليل على العفة والجود، وهما فضيلتا القوة الشهوانية، والمجاهدة بأنفسهم تدل على الشجاعة والحلم، فضيلتا الحمية أو القوة الغضبية، كما دعاها ابن سينا وأفلاطون. أما المصدر الصوفي فيبدو جليا في الفصول الأخيرة من الكتاب والتي تدور على مناهج السائرين إلى الله تعالى، والعلامات الدالة على صدق هؤلاء السائرين، وعلى حقيقة القرب من الله عز وجل مستشهدا بالحديث القدسي المعروف : "لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت له سمعا وبصرا، فبي يسمع وبي يبصر". يبدأ الغزالي كتابه بالحث على طلب السعادة الأخروية، لأن الفتور عن طلبها حماقة. يقول: "السعادة الأخروية التي نعنيها بقاء بلا فناء، ولذة بلا عناء، وسرور بلا حزن، وغنى بلا فقر، وكمال بلا نقصان، وعز بلا ذل". أي أن هذه السعادة تمثل أرقى ما يمكن أن يصل إليه العقل من الآمال والطموحات. أما السبيل إلى إدراك هذه السعادة فهو العلم والعمل، ولا بد من اقترانهما لبلوغ السعادة والنجاة، هذا ما أجمعت عليه الفرق الفلسفية والصوفية على السواء. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾(فاطر: من الآية10). والكلم الطيب يرجع إلى العلم عند البحث، والعمل كالخادم له، يرفعه ويحمله، وهذا تنبيه إلى رفعة العلم. وقد اتفق المتصوفة وبعض الفلاسفة الذين آمنوا بالآخرة على أن بلوغ السعادة يكون بالعلم والمجاهدة معا وإن اختلفوا في الكيفية. بيان تزكية النفس وقواها وأخلاقها على المرء أن يعرف نفسه وقواها وخواصها ليمكن له مجاهدتها ورياضتها. فقد قال الله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس:9-10). وإن الله عز وجل عظم من عرف نفسه تخصيصاً وإكراماً له، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾(الحجر:29). وهذا تنبيه على أن الإنسان مخلوق من جسم مدرك بالبصر، ونفس مدركة بالعقل والبصيرة لا بالحواس، وأضاف جسده إلى الطين، وروحه إلى نفسه، وقد أراد عز وجل بالروح ما نطلق عليه نحن النفس، منبها أرباب البصائر أن النفس الإنسانية من الأمور الإلهية وأنها أجل وأرفع من الأجسام الخسيسة. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم حيث جاء في قوله تعالى : ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً﴾(الإسراء: 85) بيان ارتباط قوى النفس بعضها ببعض يرى الغزالي أن قوى النفس متفاوتة الرتب. فبعض هذه القوى أريدت لنفسها، وبعضها أريدت لغيرها. وأما الرئيس المطلق منها، فهي التي تراد لنفسها ويراد غيرها لها، ولا يكون ذلك إلا في الرتبة الأخيرة التي تتفاوت فيها رتب الأنبياء والأولياء. وإن الله تعالى خص الإنسان وميزه بقوى نفسية ميزته عن سائر المخلوقات. وما عدا هذه القوى، فإن الإنسان يشترك مع غيره بجملة من الصفات، خاصة وأنه خلق على رتبة بين البهيمة والملك. فهو من حيث يتغذى وينسل فنبات، ومن حيث يحس ويتحرك فحيوان، ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على حائط ، وأما خاصته التي من أجلها خلق، فخاصة العقل، وإدراك حقيقة الأشياء. فمن استعمل جميع هذه القوى قصد بلوغ العلم والعمل معا، فقد تشبه بالملائكة، فحقيق بأن يلحق بهم وجدير بأن يسمى ملكا وربانيا، وذلك مصداقا لقوله تعالى: "إن هذا إلا ملك كريم". وأما من صرف همته إلى إتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام، فقد انحدر إلى مستوى البهائم، فيصير إما شرها كخنزير، وإما صرعة ككلب، وإما حقودا كجمل، وإما متكبرا كنمر، أو ذا روغان كثعلب، أو يجمع ذلك كله كشيطان مريد... وعلى العموم، فإن من تصفح القوى التي ذكرناها، عرف مقتضيات العقل من أرفعها وأعلاها، فينظر بعين التعجب كيف يخدم بعضها بعضا خدمة ضرورية. وأما البدن فهو آلة النفس ومركبها، تقتنص به بواسطة الحواس مبادئ العلوم التي تستنبط منها حقائق الأمور. ثم هناك العقل العملي، وهو لأجل تدبير البدن، ويخدمه الوهم، والوهم يخدمه قوتان : قوة بعده وقوة قبله. فالقوة التي بعده هي الحافظة. وأما القوة التي قبله فهي جميع القوى الحيوانية. بيان مفارقة الصوفية طريق غيرهم إن جانب العمل متفق عليه من حيث أنه مقصود لمحو الصفات الرديئة وتطهير النفس من الأخلاق السيئة. ولكن جانب العمل مختلف فيه فتباينت فيه طرق الصوفية مع غيرهم من النظار والفقهاء من أهل العلم. فإن الصوفية لم يحرضوا على طلب العلم ودراسة ما صنفه المصنفون في البحث عن حقائق الأمور، بل قالوا: "الطريق تقديم المجاهدة لمحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها، والإقبال بكل الهمة إلى الله تعالى، إذ الأولياء والأنبياء انكشفت لهم الأمور وسعدت نفوسهم بنيل كمالها لا بالتعلم، بل بالزهد في الدنيا والإعراض عن علائقها والإقبال بكل الهمة على الله تعالى، فمن كان لله كان الله معه". فالصوفية ردوا الأمر إلى تطهير محض للنفس من جانب الإنسان، حتى إذا ما صفت وطهرت مما شابها من العلائق، أصبحت مستعدة لإدراك الحقيقة ومعرفة ذات الله عز وجل. وأما النظار فلم ينكروا وجود هذا الطريق، وهو أكبر أحوال الأنبياء والأولياء، ولكنهم استوعروا السلوك فيه، فأثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج، ويختلط العقل ويمرض الجسد. فإذا لم تكن النفس قد تريّضت بالعلوم الحقيقية البرهانية فقد تتعرض لخيالات تظنها حقائق تنزل عليها، إذ كم من صوفي بقي في خيال واحد عشر سنين إلى أن تخلص منه، فلو كان يتقن العلوم والبراهين لما تعرض لذلك. أما النبي (ص) فقد كان فقيه النفس من غير اجتهاد، ولو أراد مريد أن ينال رتبته بمجرد الرياضة النفسية فقد توهم توهما بعيدا. إذا، يجب تحصيل ما حصله الأولون أولاً، ثم لا بأس بعد ذلك من الانتظار لما لم ينكشف للعلماء الباحثين عن الأمور الإلهية، فإن ما لم ينكشف للخلق أكثر مما انكشف. بيان جنس العلم والعمل الموصلين إلى جنة المأوى يقسم المؤلف العلم إلى نظري وعملي. وأما النظري فكثير، ونحن نبتغي من العلم تبليغ النفس كمالها لتسعد بهذا الكمال، مبتهجة بما لها من البهاء والجمال أبد الدهر. وهذا العلم هو العلم بالله وصفاته وملائكته ورسله وكتبه، وبملكوت السماوات والأرض وعجائب النفوس الإنسانية والحيوانية من حيث أنها مرتبطة بقدرة الله عز وجل لا من حيث ذواتها. أما القسم الثاني من العلم فهو العملي، وهو ثلاثة علوم: علم النفس بصفاتها وأخلاقها، وهو الرياضة ومجاهدة الهوى، وعلمها بكيفية المعيشة مع الأهل والولد والخدم، وعلم سياسة أهل البلد والناحية وضبطهم، ولهذا كان علم الفقه. "فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته". وأما مجامع القوى التي لا بد من تهذيبها فثلاث: قوة التفكير، وقوة الغضب، وقوة الشهوة. ومهما هذيت قوة الفكر وأصلحت، كما ينبغي، حصلت بها الحكمة التي أخبر عنها الله عز وجل حيث قال : ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً﴾(البقرة: من الآية 269). وثمرة هذه الحكمة أن يتيسر للمرء الفرق بين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الجميل والقبيح في الأفعال، ولا يلتبس عليه شيء من ذلك مع أنه الأمر الملتبس على أكثر الخلق. ومهما أصلحت القوى الثلاث وجعلت القوتان المنقادتين إلى الثالثة، التي هي العقلية الفكرية، فقد حصلت العدالة. وبمثل هذا العدل قامت السماوات والأرض، وهي جماع مكارم الشريعة وطهارة النفس وحسن الخلق المحمود حيث قال (ص): أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً وألطفهم بأهله". وقال تعالى لمن قهر هواه: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾(النازعـات:40-41)". بيان أمهات الفضائل الفضائل وإن كانت كثيرة فإنها تتمثل بالفضائل الأربع التالية : الحكمة، الشجاعة، العفة، والعدالة. فالحكمة فضيلة القوة العقلية، والشجاعة فضيلة القوة الغضبية، والعفة فضيلة القوة الشهوانية. وأما العدالة فعبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب فبها تتم جميع الأمور، لذلك قيل أنه بالعدل قامت السماوات والأرض.أما الحكمة، فهي ما عظم الله تعالى بقوله : " ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ". وقال(ص): "الحكمة ضالة المؤمن". ويندرج تحت فضيلة الحكمة الفضائل التالية: حسن التدبير، وجودة الذهن، ونقابة الرأي، وحسن الظن... وأما فضيلة الشجاعة فتشتمل على الفضائل التالية: الكرم، النجدة، كبر النفس، الاحتمال، الحلم، الثبات، والنبل .. أما فضائل العفة فهي: الحياء، والمسامحة، وحسن التقدير، والانبساط، والقناعة، والهدوء، والورع، والمساعدة.. وقد أسهب المؤلف في تفصيل كل من هذه الفضائل التي لا مجال لذكرها في هذا المقام. بيان ما يحمد ويذم من شهوة البطن والفرج والغضب لقد تنبه الشرع إلى أن هناك علاقة أساسية بين النفس والجسد، فالمعدة مفتاح الخير والشر، فيجب التقوى بالطعام لما يقيم الأود ويعين على القيام بواجب العلم والعمل, أما الإسراف فمكروه حتى وإن كان طعاما حلالا، إذ روى عن رسول الله (ص) قوله: ما من وعاء أبغض إلى الله تعالى من بطن مليء من حلال ". وقال أيضا : البطنة أصل الداء، والحمية أصل الدواء، عودوا كل جسد ما اعتاد ". وقد أقر الطب الحديث والقديم على السواء بأنه ـ (ص) ـ قد أحاط بكلماته المعدودة بكل ما توصل إليه الطب بهذا المجال. فإن امتلاء المعدة إذا زاد عن الحد المعقول قد يقود إلى الشهوة، وهذه بدورها تقود صاحبها إلى الهوى فتحول بينه وبين العبادة والتمجد لله تعالى. وقد روى أنه قيل لأحدهم: ما بالك مع كبرك لا تتعهد بدنك وقد أنهد؟ فقال: "لأنه سريع المرح، فحش الشر، فأخاف أن يجمع بي فيورطني، ولئن أحمله على الشدائد أحب إلي من أن يحملني على الفواحش". أما المحظور من الطعام والشراب، فهو تناول المحرمات ومال الغير والشراب المسكر. إذ لا يخفى ما للمسكر من أثر عظيم على العقل فيصبح غير قادر على التمييز بين الخير والشر، فتكون الفرصة سانحة للشيطان لكي يتحكم بفريسته فيرتكب هذا الفواحش والمعاصي دونما رادع.. أما شهوة الفرج، فتنقسم أفعالها إلى محمود ومكروه ومحظور. أما المحمود، فهو المقدار الذي لا بد منه لحفظ النوع، فإن النكاح ضروري لبقاء نوع الإنسان باتصال نسله، والشهوة خلقت باعثة بطريق الوطأ، ولذلك قال (ص): "تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا، فإني مباه بكم الأمم". فإن النكاح محمود لأمرين: الأول إنجاب الأبناء الصالحين، والثاني البعد عن الفجور الذي نهى عنه الدين. وأما المكروه، فأن يكثر التمتع وقضاء الشهوة فقط، وربما تناول أحدهم ما يزيد في شهوته، وذلك مضر شرعاً، ولا كراهية فيه بحد ذاته، ولكنه انصراف عن الله تعالى إلى إتباع الهوى والتشبه بالبهائم التي تسيرها غرائزها. وأما المحظور من أفعال الشهوة، فينحصر في أمرين: أما الأول، فهو قضاء الشهوة من حيث أمر الله تعالى، ولكن دون عقد شرعي، وهو الزنا، وقد قرن ذلك بالشرك حيث قال عز وجل: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾(النور: من الآية 3). أما الثاني، فتعاطيه في غير الموضع الذي أمر الله به، وهو أفحش من الزنا، لأن الزاني لم يضيع الماء، بلا وضعه في محل الحرث ولكن على غير الوجه المأمور، أما هذا فقد ارتكب معصية إضافية بأن خالف أمر الله تعالى، فكان ممن قال الله عز وجل: "ويهلك الحرث والنسل". ولذلك سميت اللواطة الإسراف، حيث جاء قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾(الأعراف:81). وأما أفعال الغضب، فإنها ليست كلها مذمومة. فالغضب هو غليان دم القلب، وعلينا أن نميز بين الغضب الذي هو عكس الحلم، وبين الغيرة على المبادئ، كالدفاع عن الدين والأوطان وذوي القربى، والتخلي عن هذا خنوثة وركاكة. ففي هذا المعنى، روى النبي (ص) قوله: "إن سعدا لغيور، وإن الله أغير منه". وقد وضع الله الغيرة في الرجال لحفظ الأنساب، ولذلك قيل: " كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها". وأما ذلك الغضب الذي يضاد الحلم، فمذموم ويجب على الإنسان أن يعمل للتخلص منه، ومن صفاته: التكبر، والانتقام، والمباهاة، والحقد، والحسد.. وأما الناس في الغضب فمختلفون. فمنهم كالخلفاء، سريع التوقد سريع الخمود، وبعضهم كالقطا، بطيء التوقد بطيء الخمود، وبعضهم بطيء التوقد سريع الخمود، وهو الأحمد، ما لم ينته إلى فتور الحمية والغيرة. وبوجه عام، فإن للبيئة المحيطة بالشخص تأثيراً عميقاً في أخلاق وسلوك هذا الشخص، وما الغضب إلا صفة من هذه الصفات التي تتأثر بما يعتاد عليه المرء من معاشرة أناس اتصفوا بالغضب، وعلى النقيض من ذلك، فإن الهدوء سينتقل إليه بمجرد تغيير بيئته... بيان شرف العقل والعلم وأما شرف العقل والعلم، فضرورة دعا إليها الشرع، حيث قال(ص): "أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي، وبك أثيب، وبك أعاقب". والدليل على أن العقل من أشرف الأشياء، أن سعادة الدنيا والآخرة لا تنال إلا به. وكيف لا يكون أشرف الأشياء وبالعقل صار الإنسان خليفة الله على الأرض، وبه تقرب، وبه تم دينه؟!.. وقد قال (ص): "لا دين لمن لا عقل له". وقال أيضاً: "لا يعجبكم إسلام امرئ حتى تعرفوا عقله". أما شرف العلم، فحسبك أن الله تعالى سمى العلم روحاً فقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الأِيمَانُ﴾(الشورى: من الآية 52). وسماه فقال: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾(الأنعام: من الآية122) ولو جلبت الأخبار التي تحث على العلم لطال المقال. وأي تشريف أكرم للعلم من قوله(ص): "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم إرضاء بما يصنع". هذه من أهم القضايا الأخلاقية التي بحثها أبو حامد الغزالي في كتابه: ميزان العمل، هذا الكتاب الذي يعد بحق من الكتب التراثية القيمة، وخصوصاً في موضوع علم الأخلاق.
|
||||||